الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
لا شك أن الفقر آفة قاتلة ومدمرة من آفات العصر، تسعى الأمم الواعية إلى علاجه والتخلص منه ومن آثاره المؤلمة في الفرد والمجتمع.
وإذا أردنا أن نسهم في حل مشكلة الفقر فنحن بحاجة إلى فهم نفسية الفقير ومعرفة خصائصه الاجتماعية فالفقر يترك على شخصية الفقير وحياته الاجتماعية ندوباً قد تعيق نموه النفسي والاجتماعي بل قد يكون معها غير قادر على مغادرة خط الفقر ولو قدمت له الأموال والخدمات اللازمة والواجبة.
فأنت ترى الإسلام ينهي عن إظهار المنة على الفقير بل ينهى عن نهر السائل حتى لا نعزز عنده الشعور بالنقص والدونية فهذا الشعور يعيقه عن الإنتاج ويضعف إرادته على التغيير إلى الأفضل.
ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة للقضاء على الفقر وحفاظاً على كرامة المهاجرين قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وعندما جاءت الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين لكنهم ردوا ما أعطي لهم واستقلوا بدور خاصة بهم واعتمدوا على أنفسهم في تحسين أحوالهم. من خلال هذه الورقة سنتطرق إلى أبرز تلك الخصائص النفسية والاجتماعية للفقير لتضيء الطريق أمام الراغبين في مساعدته لمراعاة تلك الخصائص واعتبارها في معالجة مشكلة الفقر وتأهيل الفقير.
مفهوم الفقر والفقير:
مثله مثل باقي المفاهيم في العلوم الاجتماعية التي تتميز بحملها مضامين ودلالات فلسفية ومعرفية ترتبط بالإنسان في المجتمع، والتي لم تلق إجماعاً تاماً حولها، فإن مفهوم الفقر قد اختلف في تحديده المفكرون والخبراء، ويبدو الاختلاف بيناً بين علماء الاقتصاد الذين يعتمدون معايير كمية، وعلماء الاجتماع الذين يركزون أكثر على الأبعاد الاجتماعية.
وتأسيساً على هذا، يسود جدل كبير بين الدارسين والمهتمين في مفهوم الفقر وتحديده واستخداماته يتم بناء على خلفيات فكرية وأيديولوجية؛ ولذلك لم يشهد الإجماع حوله، لاستخداماته المختلفة في سياقات متباينة وتحديد نطاقه بكيفيات مختلفة، وعليه يبقى مفهوماً نسبياً يجب التعامل معه من هذا المنظور. ولهذا نلاحظ تنوعاً كبيراً في تحديد ظاهرة الفقر.
بحصرها في عدة مؤشرات تارة يغلب عليها الطابع الكمي وتارات أخرى يغلب عليها الطابع الكيفي، ولكن مهما تنوعت الرؤى فإن مفهوم الفقر الذي تشترك حوله كل المحاولات التعريفية، يوحي بالعجز في تحقيق الحاجات المادية والمعنوية للفرد، وذلك بغض النظر عن محددات الفقر التي تشير إلى ربطه بنمط إنتاجي محدد، أو إلى مؤشراته التي تعكس مختلف مظاهر الفقر كالتواكل، الاتكالية، القدرية، الخمول... الخ (قيرة وآخرون، 17: 2003).
إذن يعد الفقر من المفاهيم المجردة النسبية حيث يحاول وصف ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد والتشابك من جهة وهو مفهوم يختلف باختلاف المجتمعات والفترات التاريخية وأدوات القياس والخلفية الفكرية والأخلاقية للمتصدي لدراسة الظاهرة من جهة ثانية. (حسن، 2004: 10)
تعريف الفقر لغةً:
(فقر) الرجل ونحوه- فقراً: كسر فقار ظهره. (فقِرَ)- فقراً: اشتكى فقارَه من كسر أو مرض. فهو فقير. (أفقر) الله فلاناً: جعله فقيراً. (افتقر): صار فقيراً. وافتقر إلى الأمر: احتاج. (الفاقرة): الداهية. (ج) فواقر. (الفقارة): واحدة من عظام السلسلة العظيمة الظهرية الممتدة من الرأس إلى العصعص... (ج) فقار.
(الفقر): العوز والحاجة، وفقر الدم: نقص به واضطراب في تكوينه يصحبه شحوب وتتابع في النفس، وخفقان في القلب. (الفقير) من لا يملك إلا أقل القوت والفقير: الواحد ممن يسمون بالدراويش (ج) فقراء. (المفاقر): وجوه الفقر. يقال سر الله مفاقره: أغناه. (المعجم الوجيز مادة فقر)
الفقر اصطلاحاً:
يشير إبراهيم (2009: 11) إلى اختلاف الباحثين في مفهوم الفقر على عدة أقوال:
الأول: أن الفقر هو عجز الفرد عن الحصول على الضروريات والحاجيات.
الثاني: أن الفقير هو الذي لا يمتلك شيئاً، والشعوب الفقيرة هي الشعوب التي يكون أغلبية مواطنيها من المعدمين وذلك تمييزا لهم عن أولئك الأغنياء الذين يمتلكون معظم وسائل الإنتاج.
الثالث: يستند أصحاب هذا الرأي على معيار الدخل. أي أن انخفاض الدخل إلى مستوى عين في السنة (ما بين 50 دولار و75 دولار بأسعار عام 1970 (في رأي البنك الدولي) يعني وجود الفقر.
الرابع: يرى القائلون بهذا الرأي أن الفقر لا يعني عدم توافر الملكية للفرد أو الشعب ولا يعني العيش عند مستوى الكفاف، وإنما يعني إحساس الفرد أو الشعب بأنه يعيش عند مستوى يقل عما يعيش عنده أفراد أو شعوب أخرى
. بينما ترى نادية حسن (2004) أن هناك ثلاثة مفاهيم أساسية في بحوث الفقر هي:
1. الفقر المطلق: يعني أن هناك مقاييس مطلقة للفقر لا توجد عليها اعتراضات. من المقبول بصفة عامة أن الفقراء في المجتمع هم أولئك الأفراد غير القادرين على اكتساب ضروريات الحياة. إن الفقر من خلال هذا المنظور هو حالة اقتصادية اجتماعية يكون فيها الأفراد غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
2. الفقر النسبي: يعني أن الفقر سياقي وعرضة للمعايير المتغيرة بتغير المواقف فالفقر ليس هو في كل مكان، وليس هو نفسه في أي مجتمع من فترة تاريخية لأخرى. هكذا لا يمكننا أن نفرض المعايير الماضية على الأوقات الحالية.
3. الفقر الرسمي: في عام 1997 كان خط الفقر الرسمي 16.276 للأسرة التي تتكون من أربعة أفراد. يعيش الأفراد في مستويات مختلفة، بصرف النظر كما يكسبونه. كذلك تتباين تكاليف المعيشة من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى وبين المناطق الريفية والحضرية. أخيرا، يفسر معيار الفقر الرسمي دخل المال ويتجاهل الوضع في الاعتبار جوانب الفقر الأخرى كالمدارس الفقيرة والرعاية الصحية وما شابه ذلك.
منظومة مؤشرات الفقر:
يشير (أوزال) إلى ستة مؤشرات للفقر على النحو التالي:
1. الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله، الوصول إلى الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة والنقل.
2. الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.
وقد تم التمييز بين نوعين من خطوط الفقر:
• حد الفقر المطلق: يعرف بأنه إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد هذه الاحتياجات سواء للفرد أو للأسرة، وفق نمط الحياة القائمة في المجتمع المعني وبحدوده الدنيا.
• خط الفقر المدقع: ويمثل كلفة تغطية الحاجات الغذائية سواء للفرد أو الأسرة، وفق النمط الغذائي السائد في المجتمع المعني وبحدود معينة.
وقد وضع البنك الدولي رقمين قياسيين يستندان إلى الحد الأدنى من الاستهلاك، ومستوى المعيشة، لقياس الفقر على المستوى العالمي بصورة عامة، والدول النامية بصورة خاصة على أساس أسعار الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1985، فالحد الأدنى للدخل هو 275 دولار للفرد سنوياً، وهو ما أسماه البنك بالفقر المدقع، والحد الأعلى للدخل هو 370 دولار للفرد سنوياً، وهو ما أسماه البنك بالفقر المطلق.
3. نسبة الفقر: تعرف بأنها نسبة السكان تحت خط الفقر إلى إجمالي السكان، وهذه النسبة تقيس الأهمية النسبية للفقراء سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أم على مستوى الأسر.
4. فجوة الفقر: يقيس هذا المؤشر حجم الفجوة الإجمالية الموجودة بين دخول الفقراء وخط الفقر أو مقدار الدخل اللازم للخروج من حالة الفقر إلى مستوى خط الفقر المحدد.
5. شدة الفقر: يقيس هذا المؤشر التفاوت الموجود بين الفقراء، ويمكن حسابه باعتباره يساوي الوسط الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية للفقراء كافة.
6. معامل جيني: يستخدم هذا المعامل كمؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخول ما بين جميع السكان فقراء وغير فقراء.
الخصائص النفسية للفقير:
1. الشعور بالنقص والدونية:
حيث يشير علوان (1401) في كتابة تربية الأولاد في الإسلام إلى أن الشعور بالنقص حالة نفسية تعتري الأولاد لأسباب خلقية ومرضية، أو عوامل تربوية، أو ظروف اقتصادية... وهذه الظاهرة هي من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه وتحوله إلى حياة الرذيلة والشقاء الإجرام... والعوامل التي تسبب ظاهرة الشعور بالنقص في حياة الولد هي كما يأتي:
• التحقير والإهانة
• الدلال المفرط
• المفاضلة بين الأولاد
• العاهات الجسدية
• اليتم
• الفقر
... أما عامل الفقر فهو عامل كبير في انحراف الولد النفسي، ويقوي جانب هذا الانحراف فيه حين يفتح عينيه ويرى أباه في ضائقة، وأسرته في بؤس وحرمان... ويزداد الأمر لديه سوءاً حين يرى بعض أقرباه أو أبناء جيرانه، أو أبناء جيرانه، أو رفاقه في المدرسة... وهم في أحسن حال، وأبهى زينة، وأكمل نعمة.. وهو كئيب حزين لا يكاد يجد اللقمة التي تشبعه، والثوب الذي يستره... فولد هذه حاله ماذا نتظر منه أن يكون نفسياً؟ حتماً سينظر إلى المجتمع نظرات الحقد والكراهية.. وحتما سيصاب بأمراض من مركبات النقص، والعقد النفسية.. وحتما سيتبدل أمله إلى يأس، وتفاؤله إلى تشاؤم.. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل –فيما رواه أحمد بن منيع والبيهقي-: "كاد الفقر أن يكون كفراً.. بل كان عليه الصلاة والسلام كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر"،
والإسلام عالج مشكلة الفقر بأمرين أساسيين:
• الأول: احترامه الكرامة الإنسانية.
• الثاني: سنه لمبادئ التكافل الاجتماعي.
2. الإحباط:
هناك تعريفات كثيرة للإحباط نستخلص منها هذا التعريف "يعرف الإحباط بأنه العملية التي تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشباع حاجته أو توقع الفرد حدوث هذا العائق في المستقبل".
يحدث الإحباط نتيجة لإدراك الفرد للظروف والمواقف التي تحيط به. وليس معنى ذلك أن الإحباط وقف على الفرد وحده، فهناك من الظروف العامة ما يسبب الشعور ب الإحباط لدى جميع الأفراد. ففي حالة المجاعة التي تحيط بجماعة ما، نجد جميع أفراد الجماعة ينظرون إلى هذا الموقف على أنه موقف إحباطي كبير. أما غير ذلك من المواقف الإحباطية، فإنها تختلف من فرد لآخر، فقد ينظر فرد إلى موقف ما، على أنه عامل إحباطي كبير، بينما ينظر إليه فرد آخر على أنه هين، وقد يسبب موقف الرضا للبعض، بينما يسبب الضيق للبعض الآخر.
وهناك عامل آخر يحدد إدراك الفرد للموقف الإحباطي، ذلك هو ثقة المرء بنفسه، فالإنسان الذي تمكنه ظروفه وإمكانياته من التغلب على ما يصادفه من عقبات، والذي أتاحت له إرضاء دوافعه، يحرز قدراً كبيراً من الثقة بالنفس. كما ستكون نظرته إلى المواقف المختلفة نظرة متفائلة تبعث على الرضا. وذلك بعكس الشخص الذي فشل في كثير من المواقف في التغلب على العقبات التي تصادفه، فإن مثل هذا الشخص تقل ثقته بنفسه، وتتلون نظرته إلى الحياة بلون قاتم متشائم.
وهكذا نرى أن درجة ثقة الفرد بنفسه تقررها المواقف والخبرات المختلفة التي يمر بها في حياته اليومية، فالمواقف المرضى يزيد من ثقة المرء بنفسه، وهي بدورها تؤثر على احتمال النجاح في المستقبل.
وثقة المرء بنفسه تحدد إدراكه للموقف الإحباطية، ذلك أن الشخص الواثق من نفسه يستطيع أن يتغلب على العوامل الإحباطية، وقد لا يهتم بالمواقف الإحباطية البسيطة. إن الشخص الضعيف الثقة في نفسه يكون حساساً لإدراك المواقف الإحباطية. وينفعل إزاءها وتؤثر في سلوكه وشخصيته إلى مدى بعيد.
وكما إن إدراك الفرد للموقف الإحباطي يعتمد إلى حد بعيد على ثقته بنفسه، فإن هذا الإدراك يتأثر أيضاً بثقته في بيئته المحيطة به، وهذه البيئة الخارجية تتضمن الأشخاص والموارد الطبيعية المحيطة بالفرد بما في ذلك من عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية، وغير ذلك مما يحيط بالإنسان فإذا كانت كل هذه العوامل تعمل بحيث تشبع للفرد دوافعه وحاجته وتعترف له بالمكانة والتقدير، فإن الفرد سوف يثق في بيئته، وستكون نظرته إليها مملوءة بالتفاؤل والأمل.
أما إذا كانت هذه العوامل البيئية تضع حواجز في سبيل تحقيق حاجات الفرد، وفي سبيل حصوله على الإشباع، فإن ثقته فيها ستقل، وبالتالي سيتوقع منها الإحباط، وعدم الاستجابة لحاجاته، وهذا سيؤثر في إدراكه للمواقف الإحباطية، وبالتالي يؤثر في سلوكه 0فهمي، 1995: 186- 188).
3. العنف:
يمكن تعريفه بأنه: سلوك يهدف إلى إيقاع الأذى بالآخرين أو ما يرمز له. وقد يكون هذا العنف فردياً أو جماعياً (منيب وسلمان، 2007: 12).
إن ما يصاحب الفقر يشكل سلسلة من الأسباب التي ربما تؤدي إلى الجريمة ثم إلى العنف، ومن ذلك ما يصاحب الفقر أو الدخل المتدني، من ضغوط اجتماعية ونفسية، وعوامل خارجية مصاحبة كالجيرة التي تغذي ثقافة قد نجد أنها مرتبطة بمشاكل أخرى كالهجرة والبطالة ومشكلات الإسكان الشعبي المتقارب ومشاكل المواصلات ونقص الخدمات الاجتماعية الأولي وهذه الظروف ربما تدفع الإنسان وتجعله أكثر ميلاً لارتكاب جرائم العنف لمواجهة الحاجات الناجمة عن هذه المشاكل.
كذلك الفوارق الاجتماعية الطبقية وسوء توزيع الثروة الوطنية والنظرة المادية التي سادت عالم اليوم جنوح الجميع إلى المظاهر الاستهلاكية والتقليد. كل ذلك يجعل (المحرومين) يعيشون صور الحقد على المجتمع ويشعرون بالتفرقة والاضطهاد والقنوط التي تترجم إلى شحنات من العنف تتفجر بمناسبة وبدون مناسبة (عبد المحمود، 2003م: 35).
بينما وجد (شو) في أبحاثه عن الجريمة وجنوح الأحداث في مدينة شيكاغو وسوء ظروفهم المعيشية، أن النسبة كبيرة من الجانحين ترجع جرائمهم وسلوكهم المضاد للمجتمع إلى سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وظروفهم الاجتماعية السيئة.
وأما مؤتمر نيويورك (1997) فقد انعقد لبحث مسلسل العنف اليومي الذي تعاني منه المدن الكبرى في العالم، فقد أشير فيه إلى الأرقام الأخيرة الرسمية التي أظهرت أن عدد الجرائم وحوادث العنف ارتفعت ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية في الدول الغربية، فقد بلغ عدد القتلى (150) ألف قتيل جراء جرائم القتل التي جرت أخيراً في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما بلغ عدد محاولات الاغتصاب نحو (256) ألف محاولة، وما يقرب من (88) ألف محاولة سطو كبيرة على بنوك ومحلات تجارية كبرى، والأعمال العنيفة تتخذ شكل عصابات من المراهقين والمتمردين على المجتمع، ويمثل ذلك هروباً من الواقع وضغوط الحياة على هذه الشريحة الكبرى من الناس التي تعاني من الفقر والقهر والمعاناة والبؤس، وذلك لقصور الأنظمة وعدالتها لتلغي التمايزات الاجتماعية، وتخفف من وجود الفوارق الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، وتقلل من عدد الفقراء والمشردين الذين جعلوا من التمرد والعنف تعبيراً عن وضعهم وما يعانون. (الشهري، 2009: 42).
وتشير دراسة التير (1418هـ) حول العنف العائلي أن أدنى النسبة المئوية للعنف العائلي كانت للذين أجابوا بكفاية الدخل وعلى العكس كانت أعلى النسب المئوية للعنف العائلي للذين قالوا بأن الدخل غير كاف. (التير، 1997: 113).
وتؤكد جونيات (2009) من خلال مقالها في مجلة حريات الأردنية والذي يحمل عنوان الفقر والعنف الأسري علاقة طردية تنعكس على سلوك الأطفال، إلى أن العنف الأسري يحدث نتيجة الفقر المدقع، أو الثراء الفاحش، بحسب الطبيب النفسي محمد الحباشنة، الذي يوضح أن العنف الأسري يتزايد على طرفي السلم الاقتصادي الاجتماعي. وهكذا، فإن الفقر وما ينتجه من ضغوط المعيشة والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة، هو أحد الأسباب الرئيسية للعنف الأسري.
الطبيب النفسي جمال الخطيب، يؤكد وجود علاقة طردية قوية بين الفقر والعنف الأسري، كما بين الظروف الاجتماعية الصعبة الأخرى، وهذا النوع من العنف. الفقر ينتج ضغطاً نفسياً هائلاً على رب الأسرة، إذ يجد نفسه مكبلاً وغير قادر على تلبية متطلبات أسرته، فيندفع لممارسة العنف تجاهها، لأنها المجال الذي يستطيع التأثير فيه، عند كل مرة يحدث فيها احتكاك مع أفراد الأسرة.
ينعكس ذلك بحسب الخطيب، على تماسك المجتمع، إذ كلما زادت حالات تفكك الأسر، ثم عدم توازن أفرادها، زادت إمكانية وقوع اختلالات مجتمعية، وتكاثرت المشاكل الاجتماعية، والاضطرابات المتعلقة بالانحراف والجنوح وما شابه.
4. المرض النفسي:
في المؤتمر الثاني عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العالمي، والذي يعد المؤتمر الأهم في الطب النفسي، لأنه يعقد تحت رعاية الاتحاد العالمي للطب النفسي، وهذا الاتحاد ينبثق عن منظمة الصحة العالمية.. وقد عقد هذا المؤتمر في اليابان، وحضره بضع آلاف من الأطباء النفسيين، وكذلك الأشخاص المهتمين بالصحة النفسية من اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وممرضين نفسيين.. في هذا المؤتمر خلص المجتمعون إلى أن السبب الأول للأمراض النفسية هو الفقر...!!
طبعاً هذا ليس بالأمر الجديد أو الغريب.. الفقر لا يقتصر فقط كونه شحاً في المال ولا نقصاً في الطعام، لكنه أيضاً السبب الأول للأمراض النفسية، وكذلك يسبب الكثير من الأمراض العضوية.
الفقر هو السبب الأول للأمراض النفسية التي باتت تشكل معضلة صحية في جميع أنحاء العالم، وأصبحت هذه الأمراض النفسية من أكثر المشاكل الصحية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين.. فتقرير منظمة الصحة العالمية يشير بأن هناك عشرة أمراض سوف تسبب إعاقة صحية، ضمن هذه الأمراض العشرة، هناك خمسة أمراض نفسية..!! هي: الفصام، الاكتئاب، الإدمان، الوسواس القهري واضطراب الوجدان ثنائي القطب.
للأسف بالرغم من أن الأمراض النفسية في ازدياد مضطر، وأن المرضى النفسيين يشكلون في مرحلة ما من المراحل في حياة البشرية ما بين 20 إلى 30% من السكان إلا أن ما ينفق على الصحة النفسية في أكثر دول العالم أقل من 1% من الميزانية المخصصة للخدمات الصحية.. هذا حسب تقارير منظمة الصفحة العالمية التي تتعلق برعاية وعناية المرضى النفسيين. الأمراض النفسية في ازدياد.. والفقر يتفاقم، خاصة في دول العالم الثالث.. والبطالة تستشري.. وهذا موضع آخر من مسببات الأمراض النفسية!.. (جريدة الرياض الجمعة 26 صفر 1452 العدد 13080 السنة 39).
ومن أشهر الأمراض النفسية القلق والاكتئاب والفصام:
• اضطراب القلق العام Generalized Anxiety Disorder
يختلف الكثير في تعريف القلق النفسي كمرض مستقل، ونستطيع تعريفه بأنه: شعور عام غامض غير سار بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر، مصحوب عادة ببعض الإحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي، ويأتي في نوبات متكررة، مثل: الشعور بالفراغ في فم المعدة أو السحبة في الصدر، أو ضيق في التنفس أو الشعور بنبضات القلب، أو الصداع، أو كثرة الحركة.. الخ (عكاشة، 2010: 138).
• الاكئتاب Depression :
أما الاكتئاب فهو مرض عصابي آخر نصادفه كثيراً هذه الأيام. وما من شخص منا إلا وانتابته لحظات في عمره- أثر أزمة خارجية، أو فقدان قريب أو صديق شعر فيها بالحزن والضياع. مثل هذا الشعور نجد يسيطر على البعض بصورة أقوى و"أطول مما هو معتاد، لهذا نسمي مثل هؤلاء مصابين بالاكتئاب.
ويكون الاكتئاب مصحوبا"ً في كثير من الأحيان بالقلق واليأس، والأرق، ومشاعر الذنب المبالغ فيها، وفقدان الشهية، والبكاء المتكرر.. وانعدام الثقة بالنفس، والتأنيب المستمر للذات، وعند نشأة الاكتئاب نجد أن نشاط الشخص يضعف ويبلد، وعلاقاته الاجتماعية تتقلص، ويتقوقع الشخص على ذاته في خيبة أمل، وعجز (إبراهيم 1994: 26).
• الفصام (سكيزوفرنيا) Schizophrenia :
الفصام هو مرض ذهاني، يتميز بمجموعة من الأعراض النفسية والعقلية التي تؤدي –إن لم تعالج في بدء الأمر- إلى اضطراب وتدهور في الشخصية والسلوك. وأهم هذه الأعراض: اضطرابات التفكير، والوجدان والإدراك والإرادة والسلوك.
وأول من سمي المرض بالفصام أو السكيزوفرنيا هو ((بلويلر)) عام 1911، أما معنى الكلمة الحرفي فمشتق من كلمتين، سكيز (Schiz) ومعناها الانقسام والانفصام، وفرينا (Phrenia)، ومعناها العقل أي انقسام أو انفصام العقل، وليس الشخصية كما يعتقد الكثيرون (عكاشة 2010: 288).
5. تدني مستوى الطموح:
فقد توصلت دراسة شبير (2005م) إلى وجود علاثة ارتباطية عكسية بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الطموح. كما أكد العيسوي (2009) على وجود خاصية أو سمة قلة الطموح بل عدم الطموح لدى الفقير، حيث خلص من دراسته إلى أن هذه السمة كانت أعلى السمات ارتباطاً بالفقراء.
وقد تناول تعريف الطموح مجموعة من الباحثين وقد عرضها شبير (2005م) ونذكر منها:
تعريف (دريفر) لمستوى الطموح بأنه: "الإطار المرجعي الذي يتضمن اعتبار الذات أو هو المستوى الذي على أساسه يشعر الفرد بالنجاح أو الفشل".
وتعريف (الزيادي) لمستوى الطموح بأنه: "المستوى الذي يتوقع الفرد أن يصل إليه على أساس تقديره لمستوى قدرته وإمكانياته".
واعتبار المساعيد مستوى الطموح بأنه: "سمة نفسية ثابتة ثباتاً نسبياً تميز الأفراد عن بعض في الاستعداد، والوصول إلى أهداف فيها نوع من الصعوبة، ويتضمن الكفاح وتحمل المسئولية والمثابرة والميل والتفوق ويتحدد حسب الخبرات ذات الأثر الفعال التي مر بها الفرد في حياته".
وتعريف رجاء خطيب لمستوى الطموح بأنه "طاقة إيجابية دافعة وموجهة نحو تحقيق هدف مرغوب فيه".
وفي اعتقادي أن الفقير أحوج الناس إلى الطموح ليغادر حالة الفقر وليبذل الجهود والمحاولة تلو الأخرى، وأما مع فقد الطموح وحتى مع توفر المساعدات المادية فقد تكون مغادرة الفقر صعبة.
الخصائص الاجتماعية للفقير:
1- الأمية وتدني المستوى التعليمي:
حيث يشير إبراهيم (2009) إلى أن الأمية ليست قاصرة على عدم تعلم القراءة والكتابة وإنما الأمية أبعد من ذلك فإن الأمية بكافة أنواعها تنتشر في البلاد الفقيرة إلى حد كبير وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
• أمية أبجدية وتعني عدم معرفة القراءة والكتابة ولقد وجدنا القرآن الكريم يدعو إلى مقاومتها في قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5))
• وأما النوع الثاني فهو أمية المتعلمين أي أن كثيراً من هؤلاء لا يتمتعون بثقافة عامة وإنما هم منحصرون في تخصصاتهم وهناك فرق بين التخصص والثقافة فالتخصص يعني معرفة كل شيء عن شيء أما الثقافة فتعني أن يعرف الإنسان عن كل شيء شيئاً وهذا أمر يؤثر عدمه في الأمم مما يؤدي إلى انتشار الفقر والتخلف إذ كل إنسان محتاج إلى أن يعرف شيئاً عن الصحة العامة ومعرفة شيء عن الاقتصاد ومعرفة شيء عن العلوم الإنسانية من تربية وعلم نفس واجتماع إلى آخره لأن كل فرد من أفراد الأمة هو زوج أو زوجة وهو أب، كما أنها أم ولها أبناء وبنات يحتاجون في التعامل معهم إلى معرفة شيء عن الأساليب التربوية ومعرفة شيء عن العلوم الإنسانية... لكن عدم ذلك يؤدي إلى الفقر والتخلف معاً.
• والنوع الثالث: الأمية الدينية وتعني عدم معرفة الناس عن دينهم فلا نقول أنه يجب عليه أن يتعلموا دينهم بما يشتمل عليه من علوم مختلفة لكن عليهم أن يعرفوا الثوابت منه. وانتفاء الأمية الدينية يساعد على ترك التقاليد البالية والعمل على الاجتهاد والبحث فيما ينفع إلى جانب الالتزام بالوارد في الكتاب والسنة. على كل حال فإن الأمية بكافة أنواعها تعد بعداً غالباً من أبعاد الفقر، ولذا فإن النوع الظاهر من أنواع الأمية هو الأمية الأبجدية والتي يتصف بها أغلب الفقراء وتتراوح نسب الأمية الأبجدية في الشعوب الفقيرة بين 33%، 93%.
ويشير (أوزال: 14) إلى سبب تدني المستوى التعليمي للفقير إلى أن الفقر يؤدي في كثير من الحالات إلى تسرب الأطفال من المدارس في سن مبكرة، إما لأغراض العمل للمساهمة في توفير دخل الأسرة، أو بسبب الظروف والأوضاع الأسرية غير المواتية، أو بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الدراسة.
2. التفكك الأسري وزيادة الطلاق:
لقد أثبتت كثير من الدراسات أهمية العوامل الاقتصادية في الحياة الاجتماعية للأفراد حيث أن انخفاض المستوى الاقتصادي للأسرة يمكن أن تنعكس آثاره على كثير من الجوانب المعيشية الأخرى كالتعليم، الصحة... الخ، ويمكن أن يمتد هذا التأثير إلى مستوى عمليات التفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة... فقد يكون فقدان القدرة على المكسب مثلا من العوامل التي تخلق التوترات في العلاقات الأسرية وأيضاً في المكانة الاجتماعية التي تحتلها الأسرة ككل والمكانة الاجتماعية التي يحتلها المسئول الأول في الأسرة على توفير الدخل، فغالباً ما يكون الدخل الذي يحصل عليه الزوج جزءاً من الصورة التي تحملها الزوجة عن زوجها، وانعدام القدرة على التكسب نتيجة المرض أو البطالة يحجب جزءاً من هذه الصورة ويهز ملامحها ويضعف الحب بين الزوجين وقد أظهرت كثير من الدراسات أن الأزمات الاقتصادية العنيفة وبطالة الزوج تؤدي في كثير من الحالات إلى زيادة في مشكلات الأسرة... والواقع أن فقدان الزوج لمنصب شغل يمكن أن يحدث انعكاساً على مستوى العلاقة بين الزوجين يمكن أن تصل على حد الطلاق (سامية).
والتفكك الأسري يقصد هنا تخلخل روابط البناء الأسري وضعف التفاعلات الاجتماعية بين أفراد الأسرة واضطراب توقعات أدوارهم والشعور بالاغتراب وانعدام الأمن والرغبة في التحلل من القيود الأسرية والاتجاه نحو الجماعات الخارجية لضعف التماسك الداخلي.
وقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن التماسك الأسري يتأثر إيجاباً بكل من درجة التزام الأسرة الديني وعدد من متغيرات الوضع الاقتصادي للأسرة هو دخل الأسرة ومستوى الحي الذي تقيم فيه ومستوى تعليم الوالد وعمل الأب ووضع الأسرة المهني والعلاقات القرابية القوية.
ومن ظواهر التفكك الأسري في المجتمع السعودي ما يلي:
• العنف العائلي: المتمثل في الإيذاء والعدوان والإكراه والحرمان الذي يقع في إطار العائلة من قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية، ويذهب ضحيتها في الغالب الضعفاء في العائلة من إناث وأطفال وتربط نتائج دراسات متعددة بين الظروف المعيشية الأسرية الصعبة من بطالة، وتدني مستوى الدخل، وتدني مستوى التعليم وكبر حجم الأسرة وتدهور حالة الحي السكني وافتقار المسكن إلى بعض الضروريات وبين تزايد العنف العائلي.
• الطلاق: ارتفعت معدلات الطلاق في المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة إلى الحد الذي بلغت فيه 12775 حالة سنويا"ً وبلغت نسبة عقود الطلاق إلى الزواج 21% وهي نسبة كبيرة ومقلقة (الشبيكي، الحوار الوطني).
3. عمالة الأطفال:
بصفة عامة، فإن عمل الأطفال هو حاضر بصفة أكثر عند البلدان النامية، وبصفة خاصة عند الطبقات الفقيرة في المجتمع والأمثلة كثيرة وثرية جداً حول أطفال ذكور وإناث دخلوا ميدان العمل... فالحديث عن عمل الأطفال أصبح يتجاوز الجدل القائم حول حقوق الإنسان إلى حقائق واقعة تنطق عن ممارسات فعلية لا يمكننا تجاهلها لأنها ستأتينا لنلاحظها حتى وإن لم نقرر نحن أنفسنا ذلك! وتختلف الصور التي يظهر عليها عمل الأطفال فمنهم من يعمل داخل البيت مع الأسرة، أو في مؤسسات صغيرة عموماً أو أخيراً في الشارع... إن وضعية أطفال الشوارع هي من أعقد مظاهر الفقر جميعها، فالطفل يغادر تماماً المدرسة في سن مبكرة حيث يجد نفسه يومياً مضطراً لتدبير قوت يومه من أجل العيش، وهو بهذا الوضع سيدخل في حلقة العمل حيث تفرض عليه منافسة الكبار بقوة، ليجد نفسه مرة أخرى مضطراً للاندماج في لعبة العمل داخل محيط الشارع مع كل ما تحمله من مخاطر، ومن أجل أن يعيش دائماً يجد نفسه يبحث عن إقامة توازنات تسمح له بتخفيف الضغط عليه من خلال اللجوء إلى المخدرات، وأن اقتضى الأمر أيضاً الدخول عالم العنف والإجرام! (سامية: 11).
4. البطالة:
أشارت العديد من الأدبيات إلى العلاقة الموجبة بين ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة، حيث وجد أن معظم الأفراد المنتمين إلى المجموعات الفقيرة هم من المتعطلين. الأمر الذي قد يرجع إلى عدم التحاق الفقراء بالتعليم أو الاستمرار فيه، مما يؤدي إلى تدني فرص حصولهم على وظائف ملائمة.
وهناك اتجاه آخر يرى تركز معظم الفقراء في الوظائف العارضة casual work أو في العمل لحسابهم self employment مثل الباعة الجائلين وليس المتعطلين فقط، مما يعني أن مشكلة الفقر لا تتمثل في نقص فرص العمل فقط وإنما تتمثل أيضاً في حجم الدخل الذي يحصل عليه الفرد كما أوضحت دراسة (19989 date et al., أن العمالة المؤقتة تتركز أكثر في الفقراء من الذكور عنها في الإناث الفقيرات (أحمد وآخرون، 2006).
5. تدني المستوى الصحي:
يرتبط المرض وبصفة خاصة أنواع منه بحالة الفقر التي تكون عليها الأسرة والمجتمع وذلك لقلة الموارد من جهة ولضعف الوعي من جهة أخرى ولقصور التغذية من جهة ثالثة، أو لما ينشأ عنها من ظروف ويتصل بها من ملابسات تؤدي كلها إلى انعدام الصحة وقائياً أو علاجياً... وسوء التغذية ونقص السعرات الحرارية والفيتامينات واعتلال الصحة بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والتي أثبتت العديد من التقارير الصحية والتنموية العالمية صلتها الوثيقة بالفقر، كما أن التفاعلات بين البيئة والصحة والفقر تفاعلات ذات دلالات واضحة فالتلوث البيئي (قذارة المياه والهواء) يعتبر مساهماً رئيسياً في الإصابة بالإسهال وأمراض الجهاز المعوي وأمراض الجهاز التنفسي وهي أكبر أسباب الوفاة شيوعاً للنساء والأطفال الفقراء حسب ما جاء في كثير من تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها المخصصة منذ عام (1990م- 2003م)
وقد توصلت إحدى الدراسات المحلية إلى عدة مؤشرات تدل على تدني المستوى الصحي للأسر الفقيرة في الأحياء الشعبية من مدينة الرياض منها تدني مستوى النظافة الشخصية، تدني مستوى النظافة العامة، إهمال صحة البيئة، نوعية الغذاء غير الجيدة إهمال رعاية الأمومة والطفولة، عدم توفر الملف الصحي العائلي لبعض الأسر، الاعتماد على الرضاعة الاصطناعية مع إهمال طرق النظافة والتعقيم واستمرار الرضاعة الاصطناعية لما بعد سن الرابعة، سوء استخدام وحفظ الأدوية وخاصة المضادات الحيوية وإهمال طرق تجنب الحوادث المنزلية، وعدم الإلمام بأساسيات الإسعافات الأولية.
كما اتضح من دراسة أخرى علاقة الظروف السكنية غير المناسبة بالإصابة بمرض الدرن وأنها قد تكون أحد الأسباب المؤدية له... والإشكالية في مرض المرأة الفقيرة في الوقت الحاضر ليس في الحصول على العلاج لأن العلاج في المجتمع السعودي بالمجان لجميع المواطنين والمواطنات ولكن ينقص المرأة الوعي المطلوب بالطريقة الصحيحة للعلاج ولتنفيذ تعليمات أخذ الدواء وذلك لارتباط فقر المرأة في الغالب بأميتها وضعف وعيها وإدراكها بأهمية تلك التعليمات وخطورة إساءة استخدام الدواء التي من الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية يصعب بعدها العلاج كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين ولا شك أن البيئة المعيشية غير الملائمة صحياً وارتفاع نسبة التزاحم السكني قد تكون عاملاً هاماً من عوامل انتقال العدوى بالأمراض وتفشي الجراثيم وبالتالي تردي الأحوال الصحية للمرضى وغير المرضى في العائلة حيث وجد علاقة بين نوع السكن وعدد مرات التنويم في المستشفيات العامة... وعندما يزداد وضع الأحوال الصحية سواء ويتطلب الأمر علاجاً متخصصاً تبدأ المشكلة الحقيقية الصحية للمرأة الفقيرة من حيث الانتظار الذي يمتد بالأشهر لمواعيد المستشفيات المتخصصة المجانية أو شبه المجانية والذي قد لا تحصل عليه بسهولة إلا من خلال مشوار طويل من التردد والإثباتات والواسطة كما هو مشاهد في أغلب الأحيان، وقد تضطر المريضة حال تعذر ذلك إلى تقديم طلب الإعانة لعلاج نفسها في المستشفيات أو العيادات الخاصة من الجمعيات الخيرية أو المحسنين أو تضطر للتسول أو إيكال التسول لأبنائها أو غير ذلك للحصول على قيمة الأدوية التي لا تصرف في الوقت الحاضر بالكمية المطلوبة حتى من المستشفيات العامة وقد تكون دائمة أو مكلفة (الشبيكي، الحوار الوطني).
6. الانحرافات الأخلاقية والجريمة:
توصلت دراسة الجيزاني (2007م) إلى أن جنوح الأحداث من أبرز الآثار السلبية للفقر في المملكة العربية السعودية. وفي إطار هذا الاتجاه فقد أكد روبرت ودسن أنه حيث تكون معدلات الجريمة مرتفعة تكون البنية الاقتصادية ضعيفة ويتمثل هذا الضعف في إهمال المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو البطالة وتزايد معدلات الخراب وتدمير الأشياء والممتلكات سبب الافتقار إلى الخدمات العامة والدعم المالي، ويوضح جيفري أهمية العوامل الاقتصادية في الدافع إلى ارتكاب الجريمة بقوله (أن المدخل الأساسي للسيطرة على الجريمة ومحاولة منعها أو ضبطها له صلة قوية بما أصبح يعرف اليوم بالتخيل الاقتصادي للجريمة)...
وتوضح بعض الدراسات التي أجريت في بلدان عربية أهمية العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الدافع إلى ارتكاب الجريمة فالدراسة التي قام بها السيد عارف العطار عن الجريمة في منظمة (الخالص) في العراق بينت أن التخلف الاجتماعي والاقتصادي والجهل وتدني المستوى التعليمي للسكان في هذه المنطقة من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الجريمة هناك وفي هذا الإطار فقد أشار الدكتور الخالدي إلى أن الظروف والعوامل الاجتماعية هي وراء ظاهرة الإدمان على المسكر والتي أصبحت تنتشر على نطاق واسع في المجتمع العربي...
إن جرائم الفقراء وجرائم الناس المسلوبي القوة غالباً ما تكون بسبب السخط والكره تجاه الأغنياء وإن الفقراء قد يحملون حملاً على ممارسة الجريمة من أجل توفير الغنى والثروة وهذا يعني أن ظروف الفقر اللاإنسانية كما يقول كلارك هي التي تخلق من بين الفقراء من يتجه إلى ممارسة الجريمة... وقد حاولت إحدى البحوث الحديثة أن تبين أن أغلب الجانحين وغيرهم من المنحرفين ينتمون إلى طبقة الفقراء والعمال غير المهرة (عادل، 2009).
كشفت دراسة علمية سعودية، أن الفقر أكبر دافع لبيان النساء أعراضهن، مشيرة إلى أن 56% من السجينات يعدن للسجن لارتكابهن جرائم أخلاقية. وكشفت دراسة علمية من العائدات إلى الجريمة قامت بها الدكتورة في علم الاجتماع أسماء التويجري أن أكبر دافع للعائدات للجريمة الأخلاقية هو العامل الاقتصادي، خصوصاً بين فئات العاطلات من العمل أو المطلقة أو التي لا ينفق عليها زوجها.
وأضافت الدراسة أن السبب الثاني هو العامل الاجتماعي مثل تعامل الأسرة مع السجينة بعد الإفراج عنها. ولقد مدير الإصلاح في سجون منطقة عسير مضواح المضواح أن البطالة والفقر هما العامل الأول للجريمة، وهو ما يدفع الناس لبيع أغراضهن. منوهاً أن العلاج والحل يبدأ من معالجة العامل الاقتصادي أولاً وقبل كل شيء (العربية 24: 2012).
التوصيات:
مما سبق يمكن أن أوصي بالتالي:
1. التأهيل النفسي للفقير مما يخلصه من الآثار النفسية للفقر والتي قد تعيقه تقدمه وتحسن أحواله.
2. التوجيه المهني وإعداده لسوق العمل للتخلص من البطالة واستثمار نقاط القوة لديه.
3. التأهيل الاجتماعي بتعليمه مهارات التعامل مع الضغوط والمحبطات وفن التعامل مع الآخرين ونحوها.
4. كل ذلك جنب إلى جنب مع تقديم الدعم المالي والخدمات اللازمة لإخراجه من بؤرة الفقر والعوز.
المراجع:
1. إبراهيم، حسني عبد السميع (2009): المعالجة الفعلية لمشكلة الفقر في ظل الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
2. إبراهيم، عبد الستار (1994م): العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث، الدار العربية، القاهرة.
3. "أحمد، شيماء وآخرون (2006)، دراسة الفقر وخصائص الفقر في مصر في إطار مسح الفقر الاجتماعي مصر 2005، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي.
4. أوزال، عبد القادر: ملاحظات حول الفقر في العالم، جامعة البليدة، كلية الاقتصاد.
5. التبر، مصطفى عمر (1997م): العنف العائلي، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
6. جونيات، بثينة (2009)، الفقر والعنف الأسري علاقة طردية تنعكس على سلوك الأطفال، مجلة حريات، العدد 60 بتاريخ 22 يناير 2009م، الأردن.
7. جريدة الرياض (1425هـ)، الفقر والسبب الأول للأمراض النفسية، الرياض، 13083، 26 صفر 1425هـ.
8. الجيزاني، خديجة (2007): تصور مقترح لمعالجة مشكلة الفقر في المملكة العربية السعودية في ضوء توجيهات التربية الإسلامية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية للبنات، قسم التربية وعلم النفس.
9. حسن، نادية جبر عبد الله (2004): الفقر وقياسه: اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة، الطبعة الأولى، دار فرحة، المنيا.
10. سامية، قطوش: معضلة الفقر: آثارها ومظاهرها، جامعة الجزائر.
11. الشبيكي، الجازي بنت محمد: المشكلات الاجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع السعودي، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
12. شبير، توفيق محمد (2005م)، دراسة لمستوى الطموح وعلاقته ببعض المتغيرات في ضوء الثقافة السائدة لدى طلاب الجامعة الإسلامية بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية التربية، قسم علم النفس، فلسطين، غزة.
13.الشهري، علي نوح (2009): العنف لدى طلاب المرحلة المتوسطة في ضوء المتغيرات النفسية والاجتماعية في مدينة جدة. رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم علم النفس.
14. فهمي، مصطفى (1995م)، الصحة النفسية، دراسات في سيكولوجية التكيف، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، القاهرة.
15. قيرة، إسماعيل وآخرون (2003): عولمة الفقر المجتمع الآخر، مجتمع الفقراء والمحرومين، الطبعة الأولى، دار الفجر، القاهرة.
16. عبد المحمود، عباس أبو شامة (2003): جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
17. عكاشة، أحمد وعكاشة، طارق (2010): الطب النفسي المعاصر، الطبعة الخامسة عشر، مكتبة الأنجلو المصرية.
18. علوان، عبد الله ناصح (1401هـ): تربية الأولاد في الإسلام، الطبعة الثالثة، دار السلام، حلب.
19. العيسوي، عبد الرحمن (2009)، تحليل ظاهرة الفقر: دراسة في علم النفس الاجتماعي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
20. عادل، شيهب (2009)، الفقر والجريمة: المفاهيم والعلاقة، مجلة العلوم الاجتماعية.
21. منيب، محمد عثمان وسليمان، عزة محمد (2007)، العنف لدى شباب الجامعة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
22. مجمع اللغة العربية (1990)، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية.
,شارك المنشور مع أصدقائك
ادرج تعليق
الرجاء تصحيح الأخطاء التالية :
{{ error }}






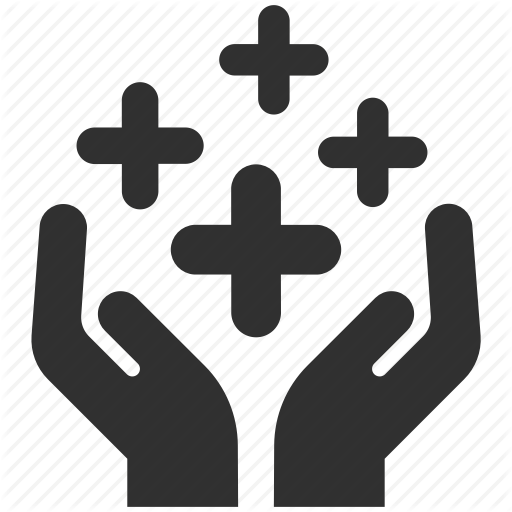
















التعليقات (0)